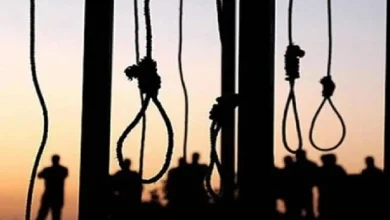فى يوم مولدي
ويمضي عمرنا عاما بعد عام ، لنترك بصمات سيرتنا منطبعة بشكل باهت على جدران الزمن، شكل لا تدركه البصائر المكبلة بأغلال (العادة) وجمود طبائعها، فنحن نعيش داخل
أسوار العادة بعبودية عمياء، فلا نستقرئ مجريات التاريخ لاستخلاص العبر من صيرورته الدائبة، ولا نصل – إلا قليلاً – لحد الاقتناع بوحدة الطريق الإنساني، وتشابهه المطلق في انتهاء الحياة، وانتفاء الخلود.
فالحياة والموت حقيقتان متتابعتان ثابتتان، وليس بقدرة منطق ان يزلزل هذه الحتمية الإلهية، غير أن المفارقة هي استمرار عبوديتنا للعادة، إذ رغم ثبات هذه الحتمية (الحياة ثم الموت) فنحن لم نتمرد على العيش داخل أضابير تلك العادة، ولم نئن من الانكفاء تحت أقبيتها الواطئة، سواء كنا متقبلين لهذا الخضوع أو رافضين له، ففى الحالتين نحن به قانعون.
أما العمر نفسه، وتراكم الخبرات فيه، فإنه يتأثر ظاهرا وباطنا بأحداث الحياة التى نعيش متفاعلين مع معطياتها، خشنها وناعمها، عنيفها ورقيقها، ناصعها وحالكها، وما بين هذه الثنائيات الحدية من وسطيات، ذلك أن خبرة الإنسان الطويلة تنمي فيه تفكيرا وسلوكا متقدمين ومتطورين باضطراد، ولكن يعوزهما النموذج المتمرد، الثائر على استبداد ( العادة) الباحث عن آلية للفكاك من أسرها، كى لا تبقى سير حياتنا كالحة، وكى نتمكن من التلويح في وجه العبودية بعلامة الانتصار، ولكن كيف ذلك؟
ستتعجب إذا قلت لك أن الثورة المطلوبة (ثورة التمرد على العادة) هى ثورة سلمية، إلى أبعد حدود التصالح مع الذات، بل إلى أرفع درجات الرضا، فإذا كانت الثورة بالمعنى السياسي قرينة العنف أو بعضه على الأقل؛ فإن الثورة بالمعنى الإنساني الذى أقصده هنا، هى انتقال (طوعي) من حالة العنف الذي يقتضيه خضوعنا للعادة، إلى حالة استرخاء نفسى، يفضي إلى السكينة، بل إلى الاستقواء بالهدوء، نعم (الاستقواء بالهدوء) وسأعود إلى ذلك فى حينه.
معروف أن حاجات الإنسان تنقسم إلى حاجات بيولوجية وأخرى مكتسبة، النوع الأول، كلنا شركاء فيه، كالحاجة إلى الطعام والشراب والإخراج والنوم، وغيرها من اللوازم القسرية لبقاء النوع، فحاجتنا إلى ذلك فطرية متأصلة في كينونتنا، لأن شأنها في ذلك شأن التنفس، لا حياة لبنى البشر دونه، ولذلك فلن أتحدث عن هذا النوع. أما النوع الثانى من الحاجات فهو ليس فطريا، وإنما اكتسبه الفرد من زخم الأحداث الاجتماعية المحيطة به، ومن معطيات التاريخ وراء زمانه، ويتمثل ذلك في السعي إلى اكتساب ( الخصوصية) والتفرد بالفوقية، ومحاولة الجلوس في الصفوف الأولى من مسرح الدنيا، أو قل – إن شئت – إن ذلك بلغة أفلاطون وتفسير فوكو ياما، هو (الثيموس) أي محاولة نزع الاعتراف من الآخرين، ونيل التقدير والاحترام. وهذا النوع من الحاجات مكتسب، لا علاقة له بالتوارث من قريب أو بعيد.
حتى نظريات داروين، ونظريات جين دي لا مارك، في توارث الصفات (المكتسبة) ثبت عدم صحتها، فقد كانا يقولان (مع التبسيط طبعاً) بأن ما اكتسبه الفرد من نمو عضلاته نتيجة لرفع الأثقال مثلا، ينتقل إلى أبنائه بالتوريث، فيجىء الطفل قويا مفتول العضلات مثل أبيه، غير أن العلماء اللاحقين قد جربوا ذلك على الفئران، فقاموا بقص ذيولها، ومع ذلك جاء أبناء هذه الفئران بذيول كاملة، فنمو أجزاء في الجسد أو قص بعضها لا يتم توريثه، وإلا كنا في غير ذي حاجة إلى (الختان) مثلاً، فمع ان الأب كان مختونا، فإن طفله يولد غير ذلك، والأمثلة كثيرة، ولكن هذا يكفي لتفنيد نظرية توارث الصفات المكتسبة (جسديا) أي تلك التي تقترن بالجسد فقط، سواء بالإضافة أو الإنقاص، ولا علاقة لها بالميول أو الاتجاهات أو النزعات، التى هى أولى – مؤكدا – بعدم القابلية للتوريث.
أما تلك الصفات الروحية والخلقية (الميول والاتجاهات والنزعات) المكتسبة من نماذج المجتمع متعدد القيم، فإنها وإن كانت لا تورث بشكل بيولوجي؛ إلا أن وقائع التاريخ تثبت أنها (معدية بشكل فكرى) وتكمن عدواها في نوع القرابة، أو في التجانس المكاني، أو بسببهما معا، فهذه المجموعات الفكرية تنتفي بيولوجيا، ولكنها لا تختفي أيديولوجيا.
فقلما (أقول قلما) نجد لصا هو ابن لأسرة شريفة، أو متدينا من أسرة منحلة، أو ابن رجل أعمال لا يحب المال، أو ابن ممثل لا يحب النجومية، أو ابن لاعب كرة لا يهوى الرياضة، أو ابن مذيع لا يعشق الشهرة، أو ابن مسئول لا يهيم بالسلطة، أو ابن عالم لا يتوق للمعرفة، وإن كنا قد رأينا أو سمعنا عن كثير من أبناء الأميين يحملون درجات علمية رفيعة (وأنا بالطبع منهم) ولكن ذلك يرجع لأسباب متعددة، أهمها ما يطلق عليه علماء السوسيولوجيا اسم (الحراك الاجتماعي) أي أثر الأوضاع الاقتصادية على اهتمام الناس بقيمة التعليم، وكذلك دور التعليم في التحرك من طبقة اجتماعية لأخرى أعلى منها.
لذلك فإن الصفات الاجتماعية التي انتقلت إلى الناس (بالعادة) الحياتية وليست بالوراثة، فأصبحت – بحكم التمرس – من قرائن وجودهم، هي ما سأكتب عنه في هذا المقام. وإذا جاء عرضي مختصرا، فللقارئ أن يحرك سواكن مخيلته بما شاء لها من توسعة.
الثروة، السلطة، النفوذ، الشهرة، وما شابه ذلك من الموارد القابلة للندرة في المجتمع، رآها الناس لا تضمن العيش فحسب؛ وإنما تؤكده بسيادة وامتياز وجودي، يفوق العيش بالكاد، أو حتى العيش بالراحة المعتادة، لقد رأى الناس في التطلع إلى مثل هذه الأماني مخرجا لهم من الرضوخ لفلسفة القطيع، ورأوا في بلوغها (كلها أو بعضها أو حتى أحدها) جلوسا على مقاعد أعلى من تلك التي يجلس فوقها العامة على قارعة الدنيا، فأصبح من عادة أفراد أي مجتمع، وفي أي زمان ومكان، الرضوخ (الإرادي) لتلك العادة (محاولة التميز) أقول (عادة) لأنها مكتسبة.
وبما أني أكتب اليوم في ذكرى مولدي (وهى الخامسة والخمسين) أي أنني عركت الحياة طولا وعرضا، بشكل استطيع معه الاستخلاص؛ فلابد أن أربط ذلك بنفسي، فأقر بأني لم أكن زاهدا (خصوصا إبان مطلع شبابي) في محاولة الإمساك بأطراف القوة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فلم أشذ عن الرغبة السائدة بين الناس (معظمهم على سبيل اليقين) بل كنت في أحايبن كثيرة من أشدهم لهثا؛ جراء قسوة التسابق في هذا المضمار، فمرة كنت أبزهم، وغيرها كنت ألحق بهم بالكاد، وأخرى كنت أقترب منهم (كثيرا أو قليلا) ولكن كل ذلك لا يعني أنني لم أعاني الفشل المطلق، لا، لقد عانيته بالتأكيد، غير أني – بصفة عامة – أستطيع القول أني لم أكن بعيدا عن (سباق التسلح) هذا، فقد عشت – لفترة ليست بالقصيرة – في غمار المنظومة، وكنت أحد تروس ماكينتها، التي تدور على هيئة تثير الدوخان.
بيد أنه يجب أن يكون معلوما أن السعي لإدراك هذه المكتسبات لا غبار عليه، بل يمكن اعتبار إنه التصميم الهندسي الأمثل لحياة الإنسان داخل بنيةالمجتمع المتغاير بطبيعته، ولكن هذا السعي التنافسي مشروط بـ (المشروعية) والمشروعية هنا لها جملة ضوابط ومحددات، وهذا هو مكمن الاختلاف بين الخضوع الأعمى (للعادة) ومحاولة تهذيبها بشكل يرتضيه المجموع، وإلا نكون قد طمسنا الخط الفاصل بين الغريزي والمكتسب، بين الفطري والذي ينقصه التحضر، بين الاستجابة للشهوة والتسامي عليها، وبالجملة بين الإنسان والحيوان.
كما يجب أن يكون معلوما أيضاً أن إسقاط المعانى على نفسى فى هذا المقام لا يميزني عن غيري قيد أنملة، ولا يوليني أفضلية خاصة على من اتخذت خطا مخالفا لخطوطهم، فحاشا لله أن أزكى نفسي عليهم، فأنا لا أدعي القداسة، ولا أقدم الغير قربانا على مذبح التطهر المزعوم، أو السمو الكاذب، بل أنني أعلم الناس بذاتي، وأدراهم بضعفها، فوحدي الذي يعرف نقائصها وأدرانها وشوائبها وكل مثالبها، ما افتضح من ذلك وما استتر، الأول فعلته أنا بنفسي، أما الثانى فقد كان من رحمة الله بي.
ذكرت فيما سبق أنني كنت منافسا – قدر طاقتي – للفوز بالمراتب الأولى في الحياة، ولازلت كذلك، وسأبقي هكذا ما تبقى لي من العيش في الدنيا، ولكن ثمة فروق متعددة بين ( المراتب الأولى) في بدايات الحياة، وما تغير بعد ذلك بحكم الوعى الذى طورته خبرة ما يربو على النصف قرن من العمر، فيا ليت وعى الكبر قد أتاني في الصغر.
نعم، كنت سأختار مسارات حياتي كما هى ( تقريبا) وكما أوصلتني تلك المسارات إلى هذه المرحلة بشىء من التطابق، ولكن (الوعى المسبق) هو ما كان سيقيني شر القلق، ويجنبني مزالق التوتر، إذ لم أكن أدرك – بحكم المرحلة – مآلات السير النهائية، ولو كنت أدركتها مبكرا (وهذا أمر صعب بطبيعة الحال) لكنت سرت على نفس الخطى، ولكن براحة اليقين، عموماً لقد أفاض العمر علي بإدراك هذه المسارات، وما لا يدرك كله لا يترك كله، وأن تأتي متأخرا خير لك من ألا تأتى على الإطلاق.
هكذا سعيت (ولو متأخرا بعض الشىء) إلى تطبيق معرفتي بالحقيقة، فأن أخضع لـ (عادات) العيش في التسابق على نيل القوة في البدايات، لهو مسلك محمود، أو قل – إن شئت – مسلك طبيعى على الأقل، طالما التزمت بمبادئ الشرف، وخضعت لقواعد اللعبة المألوفة، ولكن غير المحمود هو اعتبار التسابق غاية في ذاته، وليس مجرد وسيلة، فيظل المرء يلهث في مضمار التسابق إلى أن يموت، وبذا يكون قد تفهم (العادة) على نحو مغلوط، وصار التقدم عنده هو أولى الأولويات، دون استدراك لخطورة المعتقد، وهو فارغ تماما من مضمون الاستقراء.
فأن تبلغ ما أردت (تقريباً) لهو أدعي أن تدرك قواعد الوصول، فتستطبع التفرقة بين الوسائل والغايات، وكم اختلطت – عندى – فيما مضى وتشابهت. أما الآن فلقد بلغت حد اليقين من معرفة الفوارق، فأرحت واسترحت، بعدما اعتصمت بحبل الاقتناع، وعلمت أن دروب البحث سواء كانت خشنة أو معبدة؛ فإنها يجب أن تكون مواصلة – بالضرورة – إلى تلك الغاية، فهدأ سيرى، ولا أقول انقطع، وارتاحت ساقاي، ولا أقول توقفت، وبرد فكري، ولا أقول تجمد، وهذا هو (الاستقواء بالهدوء) الذي قصدته في بدايات المفال، وهو تذوق خاص للشرب من كأس الحياة، ربما لا يكون الأفضل أو الأكثر استساغة، ولكنه مختلف، ربما لا يكون (الثيموس) بلغة أفلاطون ولا (السوبرمان) بلغة نيتشة؛ ولكنه – بمفهومي أنا – نوع آخر من التقدم، يغاير تمامآ الخضوع (لعادة) التسابق فيما تقدم من العمر، ويمحو كل آثار التبعية لمنطق المتصارعين (مدى الحياة).
لقد أعطيت نفسى – في أخريات عمري – فرصة لاستخلاص النتائج، وشاء الله أن أتوقف – ولو متأخرا – عن الاستغراق فى الغيبوبة، عن الاستمرار المضني في لعبة الليل والنهار، فبعد كل الأخذ بالأسباب طبعآ، وصلت إلى ( زهد خاص) زهد تساوي فيه – عندى – ذهب الحياة بترابها تقريبا، وعفة شبه كاملة، تساوت فيها كل مقاعد الحياة، واتسعت وكثرت لراحة كل الجالسين، وذلك نوع من الاشتراكية (النفسية) إن صح التعبير، التي يكون بها الإنسان (ليبراليا) من الناحية الروحية، إلى أعلى مستويات الحرية. ألم أقل لكم اني سأبقى طيلة عمري باحثا عن الخصوصية؟!
ولكن (الخصوصية) في مراحل حياتي ( الأولى) كانت بحثا عن (التفرد) وكان فى ذلك امتياز مرحلي لا ريب، أما الآن، فخصوصيتي هى فلسفة (التشارك) أو (النجاح الجمعي) أو تذويب التفوق الشخصي في التفوق الكلى العام، أو إصهار الإنجاز الفردى في سبيكة نجاح الآخرين، وذلك يتضمن إنكارا للذات، لا يستطيعه إلا العازمون، أو بمعنى أدق الأقوياء الواثقون من قدرتهم على التخلص من قيود ( التشخصن) الذاتى، ففي ذلك مجاهدة تفوق – بمراحل – تلك التي كانت مطلوبة لخصوصية (التفرد) فيما مضى، والتي لا يزال البعض، وسوف يظلون مدى حياتهم متورطين فى براثنها.
وكان بحثي عن (التفرد) في بداية تكويني مسلكا دراسياً في المقام الأول، ولم يكن ثمة ما يفوقه أو حتى يساويه، وأقصد بذلك مهنة الأب، فأنا لم أسع أبدا أن أعيش في جلبابه، وإنما كنت أخف الخطى نحو التفوق العلمى، ولا أهتم بمهنة أبي (الزراعة) إلا عن طريق المساعدة فقط، بالشكل الذى يرضيه عنى، وكنوع من المساهمة فى تحصيل الرزق الذي أقتات منه، وأتابع مسيرة تعليمي.
لقد ذكرت فيما سبق أن (النزعات والميول والاتجاهات) قد تنتقل عدواها إلى الأبناء، فإما هم يميلون فيها إلى تقليد آبائهم، وتكملة السير على دروبهم، أو أن آباءهم يحببون الأبناء فيها، اعتزازا بالمهمة، واستكمالا للطريق، والحق أن الأمرين لم يتحققا معى، فلا أنا رغبت في مهنة أبى (الفلاحة ومشاقها) نظرا لمصاعب المهنة في قيظ الصيف وزمهرير الشتاء، ولا هو – والحق يقال – حثنى عليها، أو رغبني فيها، أو زينها لي، بل كان ينفرني من متاعبها (وليس من قيمتها بالطبع) ويتمنى لي مستقبلا ذا حظ أوفر من الراحة ونعومة العيش، فكان يمسك بيدي الصغيرة البضة، ويقول مبتسما : هذه يد خلقت للقلم وليس للفأس، فاجتهد يا بنى دراسياً ، كى لا تتحول نعومة يديك إلى خشونة يدي.
ولكن ألم تر معي أيها القارئ، أن المهن الشاقة فقط هى تلك التي (لا) يرغب الآباء في توريثها لأبنائهم؟ فلو أن أبي – مثلاً – كان ( رئيسا) أتراه لم يكن ليرغبني في وراثة السلطة، أو على الأقل يعمل على إغرائى بسحرها؟
أما هو، فلم أكن لأضمن ذلك، لأنه – ببساطة – أب، وأما أنا، فأكاد أجزم بأنني لم أكن لأقبل ذلك، لزهدى الحالى، وترفعي عن الانتصارات المزيفة، ومخاصمتي لمبدأ الصعود على أكتاف الآحرين، وهى القيم التي غرستها فى ذاتى مسارات حياتي السابقة، ونظرتى المختلفة للحياة، أقول أننى كنت سأرفض بالقطع، ولكن بشرط واحد، وهو أن تكون حياتي قد سارت على نفس خطاها القديمة، وهذا أمر مشكوك فى يقينيته.
أقرأ التالي
11/05/2024
عندما يتجاوز النظام الايراني کل الحدود
11/05/2024
التهديد الأخطر لأمن المنطقة ومستقبلها
10/05/2024
نقطة جوهرية لاخلاف بشأنها
10/05/2024
کراهية ورفض نظام الملالي داخليا وخارجيا
09/05/2024
ماذا تعني الهجمات المستمرة على مقرات حرس ملالي إيران؟
09/05/2024
حرب غزة فضحت النظام وليس دعمته