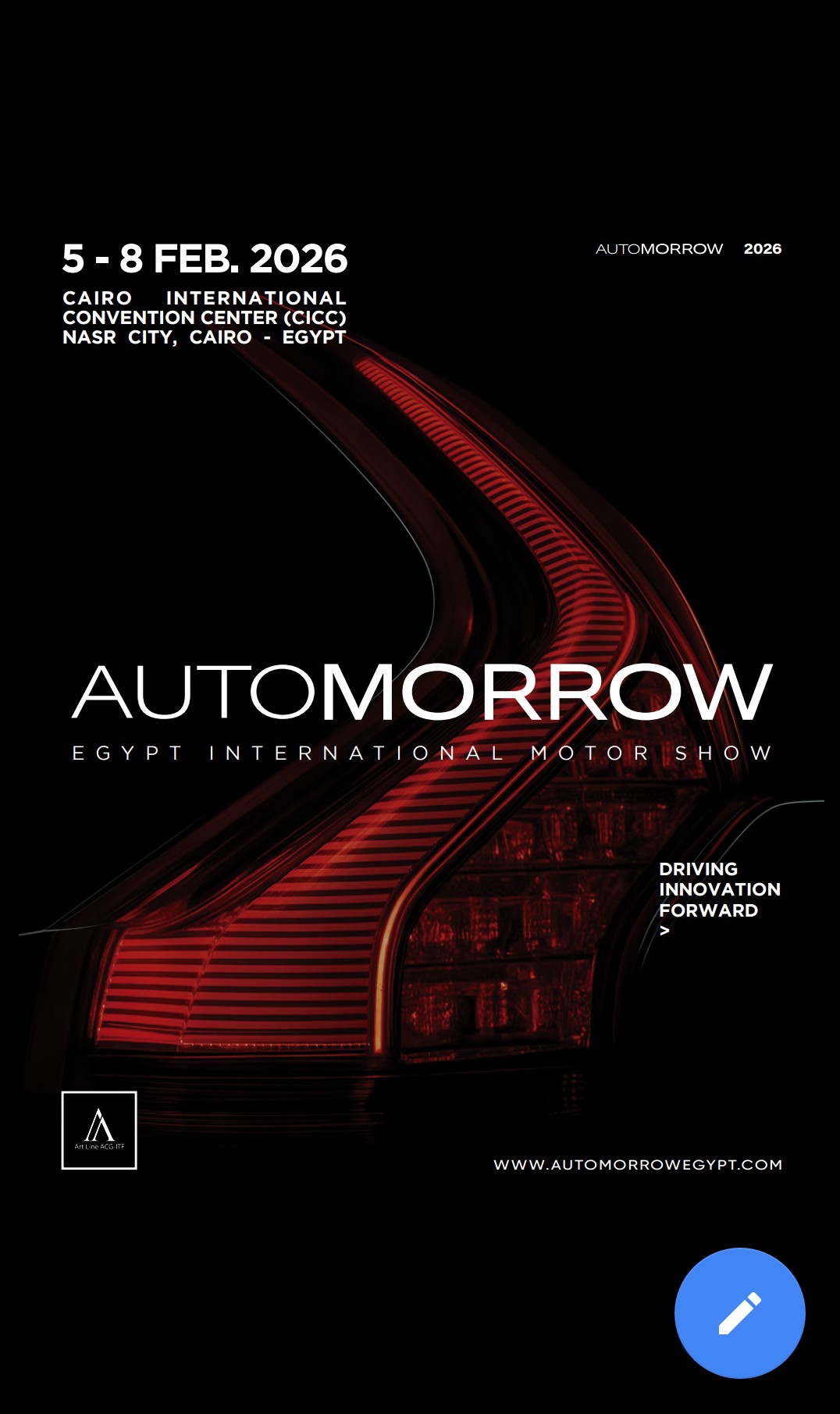دراسة نقدية لمسلسل مقدمة: الإرث التاريخي في عباءة الدراما مسلسل “المؤسس عثمان” هو امتداد طبيعي لسلسلة “قيامة أرطغرل”، وقد شكّل ظاهرة جماهيرية منذ انطلاقه عام 2019. يعرض المسلسل سيرة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، ويعتمد على مزيج من الوقائع التاريخية والتخييل الدرامي. هذه الدراسة تستعرض عناصر القوة والضعف في هذا العمل من حيث السيناريو، الإخراج، التمثيل، الموسيقى، ومشاهد المعارك، وتتناول كيف ساهم هذا الإنتاج في ترسيخ صورة رومانسية وسياسية لتاريخ معقد. أولاً: السيناريو والحبكة الدرامية 1. الحبكة: بين التاريخ والأسطورة السيناريو الذي كتبه محمد بوزداغ يميل إلى بناء قصة تتجاوز المادة التاريخية إلى نوع من الأسطرة البطولية. فشخصية عثمان تُقدَّم كبطل خارق، لا يخطئ، دائم الظفر، بما يحول السرد أحيانًا إلى تمجيد مفرط يُفقد القصة شيئًا من مصداقيتها. ورغم ذلك، فإن الخط السردي ينجح في الحفاظ على عنصر التشويق عبر الحلقات المتعددة، من خلال تنويع الصراعات: بين القبائل، وبين العثمانيين والبيزنطيين، وبين الأتراك والمغول. تُبنى كل حلقة على ذروة درامية تؤسس لتتابع متماسك، وإن بدا أحيانًا مكررًا أو مطولًا بلا مبرر. 2. الشخصيات: العمق الغائب الشخصيات الرئيسية مثل عثمان، بالا خاتون، وبوران ألب، رُسمت بشكل نمطي: البطل النقي، الزوجة الوفية، المحارب الشرس. ونادرًا ما تُمنح الشخصيات الثانوية مساحة تطور حقيقية، مما يجعل كثيرًا منها مجرد أدوات دعم درامي. في المقابل، ينجح المسلسل في تقديم بعض الأعداء بصورة معقدة مثل نيكولا أو روغاتوس، وإن ظلوا غالبًا محكومين بثنائية “الشرّ المطلق”. ثانيًا: الإخراج والتصوير 1. الإخراج: ملحمي أم متكلف؟ المخرج متين غوناي يمتلك عينًا سينمائية بارعة، خاصة في تصوير مشاهد الغروب، والتنقل بين المناظر الطبيعية المفتوحة واللقطات القريبة. يعمد إلى استخدام الإضاءة الباردة في مشاهد الصراع، والدافئة في لحظات الصفاء والروحانية. لكن يُلاحظ الإفراط في استخدام اللقطات البطيئة (slow motion)، خصوصًا في المعارك والخطب، مما يُضعف أحيانًا من الإيقاع ويُدخل المشاهد في حالة من الملل. كذلك فإن بعض مشاهد الحوار الطويلة – رغم جمال اللغة – تشبه المسرح أكثر من الدراما الحديثة. 2. المشاهد الداخلية: ثبات مبالغ فيه يعاني الإخراج أحيانًا من الجمود داخل المشاهد الداخلية، حيث يكثر استخدام زوايا ثابتة ولقطات واسعة تفتقر إلى الحركية. هذا يتناقض مع الحركية الشديدة في المشاهد الخارجية، مما يكشف عن خلل في التوازن البصري. ثالثًا: المعارك والمؤثرات البصرية 1. تصميم المعارك: ملحمي لكنه غير واقعي لا شك أن مشاهد القتال تُعد من أكثر عناصر المسلسل إثارة، حيث يتم استخدام جيوش حقيقية، وخيول، وأسلحة تقليدية، ما يمنحها طابعًا ملحميًا. ومع ذلك، هناك ميل واضح إلى المبالغة في قوة عثمان ورجاله؛ فعدد محدود منهم يقهر جيوشًا بأكملها، ما يُضعف من مصداقية الحدث. 2. التنسيق الحركي: نجاح متفاوت يُشيد النقاد بتنسيق القتال الفردي (خاصة مبارزات السيوف)، لكن المعارك الجماعية تعاني أحيانًا من فوضى بصرية، أو تكرار في الحركات، أو أخطاء إخراجية كظهور جنود يسقطون قبل أن يُضربوا فعليًا. في المقابل، نجح المسلسل في خلق مشاهد معارك ليلية مثيرة باستخدام الإضاءة والظلال والمؤثرات الصوتية. رابعًا: الموسيقى والديكور والأزياء 1. الموسيقى التصويرية: بين التأثير والابتذال الموسيقى التي ألفها زينب ألاس تُعد من علامات المسلسل البارزة، وتمنحه هوية سمعية قوية. إلا أن تكرار بعض المقطوعات دون تجديد يُفقدها أحيانًا تأثيرها. ورغم جمال المقامات الشرقية المستخدمة، يظل غياب التنوع أحد أبرز مآخذها. 2. الأزياء والديكور: واقعية جزئية تبدو الأزياء مفصلة بعناية، وتستند إلى نماذج تاريخية مقاربة، إلا أن بعضها يميل إلى البهرجة. أما الديكور، خاصة داخل الخيام ومجالس الشورى، فيبدو مسرحيًا ومصقولًا أكثر من اللازم، ويفتقر إلى الطابع الترابي الواقعي للقرن الثالث عشر. خامسًا: البعد السياسي والإيديولوجي 1. النزعة القومية والدينية المسلسل يعكس توجهًا تركيًا واضحًا نحو تمجيد الهوية العثمانية والترويج لفكرة الدولة الإسلامية الجامعة. وتُستخدم الخطب الدينية والمشاهد الروحانية (مثل لقاءات الشيخ أديب علي) لترسيخ رمزية عثمان كبطل “مختار من الله”. يُوظف المسلسل هذه الرمزية في سياقات سياسية معاصرة، مما يجعله – وإن بدا تاريخيًا – أداة خطاب معاصر يستجيب لتوجهات قومية تركية بقيادة العدالة والتنمية. 2. تغييب السياق التاريخي المعقد لا يُعير المسلسل اهتمامًا كبيرًا للتفاصيل السياسية الحقيقية المعقدة في تلك المرحلة، مثل علاقات التحالف والمصالح المتبادلة بين القبائل، أو انقسامات العالم الإسلامي. بل يميل إلى سردية تبسيطية تقسم العالم إلى “كفار وأعداء” مقابل “عثمان ومناصريه”. سادسًا: الأداء التمثيلي 1. بوراك أوزجيفيت (عثمان): جاذبية وحضور يؤدي بوراك دوره بحضور قوي وكاريزما ملحوظة، لكنه يعتمد أحيانًا على تعبيرات وجه واحدة (التجهم أو الحزم)، ما يُفقد الشخصية أبعادها الإنسانية. يبرع في مشاهد القتال والخطب، لكنه يضعف في التعبير العاطفي. 2. باقي الطاقم: تفاوت واضح تتنوع مستويات الأداء بين ممثلين متمكنين (مثل أركان أفر، الذي أدى دور دوندار ببراعة) وآخرين أقل تمكنًا، خاصة في الأدوار النسائية، التي كثيرًا ما تُقدَّم بصورة مسطحة رغم محاولات القوة والتمكين. خاتمة: بين الفن والدعاية “المؤسس عثمان” عمل درامي ضخم يجمع بين المتعة البصرية والسرد البطولي، لكنه يعاني من مشكلات تتعلق بالمصداقية التاريخية، والمبالغة في التمجيد، وتكرار النمطية. لا يمكن إنكار أثره الجماهيري، ولا دوره في إحياء الاهتمام بفترة منسية من التاريخ، لكنه في نهاية المطاف يظل عملًا دراميًا أكثر منه توثيقيًا، يخدم رؤية أيديولوجية محددة تحت عباءة الترفيه الملحمي.
صالون الأديب الدكتور سليمان عوض يحتفي برواية (صباح ينتظر الفرح) للكاتب الصحفي والأديب أحمد فتحي رزق
في مساء صيفي جميل يحتفي صالون الأديب الدكتور سليمان عوض برواية (صباح ينتظر الفرح) للكاتب الصحفي والأديب أحمد فتحي رزق الجمعة 28 يونيو بوسط القاهرة
إسرائيل تلفظ أنفاسها الأخيرة
إعداد _ أشرف المهندس يقول الدكتور اسماعيل المرشدى من علماء الأوقاف نشرت صحيفة “هآرتس”العبري مقالاً للكاتب الصهيوني الشهير (آري شبيت) يقول فيه :*يبدو أننا نواجه أصعب شعب عرفه التاريخ ولا حل معهم سوى الإعتراف بحقوقهم وإنهاء الاحتلال. بدأ “شبيت” مقاله بالقول: يبدو أننا اجتزنا نقطة اللا عودة ويمكن أنه لم يعد بإمكان “اسرائيل” إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وتحقيق السلام ويبدو أنه لم يعد بالإمكان إعادة إصلاح الصهيونية وإنقاذ الديمقراطية وتقسيم الناس في هذه الدولة. وأضاف: إذا كان الوضع كذلك فإنه *لا طعم للعيش في هذه البلاد وليس هناك طعم للكتابة في “هآرتس” ولا طعم لقراءة “هآرتس” ويجب فعل ما اقترحه (روغل ألفر) قبل عامين وهو مغادرة البلاد. إذا كانت “الإسرائيلية” واليهودية ليستا عاملاً حيوياً في الهوية وإذا كان هناك جواز سفر أجنبي لدى كل مواطن “إسرائيلي” ليس فقط بالمعنى التقني بل بالمعنى النفسي أيضاً فقد انتهى الأمر. يجب توديع الأصدقاء والانتقال إلى سان فرانسيسكو أو برلين أو باريس. من هناك من بلاد القومية المتطرفة الألمانية الجديدة أو بلاد القومية المتطرفة الأميركية الجديدة يجب النظر بهدوء ومشاهدة “دولة إسرائيل” وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة. يجب أن نخطو ثلاث خطوات إلى الوراء لنشاهد الدولة اليهودية الديمقراطية وهي تغرق. يمكن أن تكون المسألة لم توضع بعد. ويمكن أننا لم نجتز نقطة اللا عودة بعد * ويمكن* أنه ما زال بالإمكان إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وإعادة إصلاح الصهيونية وإنقاذ الديمقراطية وتقسيم البلاد وتابع الكاتب: أضع أصبعي في عين نتنياهو وليبرمان والنازيين الجدد لأوقظهم من هذيانهم الصهيوني. إن ترامب وكوشنير وبايدن وباراك أوباما وهيلاري كلينتون ليسوا هم الذين سينهون الاحتلال. وليست الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هما اللذان سيوقفان الاستيطان والقوة الوحيدة في العالم القادرة على إنقاذ “إسرائيل” من نفسها هم “الإسرائيليون” أنفسهم وذلك بابتداع لغة سياسية جديدة تعترف بالواقع وبأن الفلسطينيين متجذرون في هذه الأرض. وأحث على البحث عن الطريق الثالث من أجل البقاء على قيد الحياة هنا وعدم الموت. ويؤكد الكاتب في صحيفة هآرتس: أن “الإسرائيليين” منذ أن جاؤوا إلى فلسطين يدركون أنهم حصيلة كذبة ابتدعتها الحركة الصهيونية استخدمت خلالها كل المكر في الشخصية اليهودية عبر التاريخ. ومن خلال استغلال ما سمي المحرقة على يد هتلر «الهولوكوست» وتضخيمها إستطاعت الحركة أن تقنع العالم بأن فلسطين هي “أرض الميعاد” وأن الهيكل المزعوم موجود تحت المسجد الأقصى وهكذا تحول الذئب إلى حمَل يرضع من أموال دافعي الضرائب الأميركيين والأوروبيين حتى بات وحشاً نووياً. واستنجد الكاتب بعلماء الآثار الغربيين واليهود ومن أشهرهم «إسرائيل فلنتشتاين» من جامعة تل أبيب الذي أكدوا “أن الهيكل أيضاً كذبة وقصة خرافية ليس لها وجود وأثبتت جميع الحفريات أنه اندثر تماماً منذ آلاف السنين وورد ذلك صراحة في عدد كبير من المراجع اليهودية وكثير من علماء الآثار الغربيين أكدوا ذلك.. وكان آخرهم عام 1968م عالمة الآثار البريطانية الدكتورة «كاتلين كابينوس» حين كانت مديرة للحفائر في المدرسة البريطانية للآثار بالقدس فقد قامت بأعمال حفريات بالقدس وطردت من فلسطين بسبب فضحها للأساطير “الإسرائيلية” حول وجود آثار لهيكل سليمان أسفل المسجد الأقصى. حيث قررت عدم وجود أي آثار أبداً لهيكل سليمان واكتشفت أن ما يسميه الإسرائيليون “مبنى إسطبلات سليمان” ليس له علاقة بسليمان ولا إسطبلات أصلاً بل هو نموذج معماري لقصر شائع البناء في عدة مناطق بفلسطين وهذا رغم أن «كاثلين كينيون» جاءت من قبل جمعية صندوق استكشاف فلسطين لغرض توضيح ما جاء في الروايات التوراتية لأنها أظهرت نشاطاً كبيراً في بريطانيا في منتصف القرن 19 حول تاريخ “الشرق الأدنى”. وشدد الكاتب اليهودي على القول: أن لعنة الكذب هي التي تلاحق “الإسرائيليين” ويوماً بعد يوم تصفعهم على وجوههم بشكل سكين بيد مقدسي وخليلي ونابلسي أو بحجر جمّاعيني أو سائق حافلة من يافا وحيفا وعكا. يدرك “الإسرائيليون” أن لا مستقبل لهم في فلسطين، *فهي ليست أرضاً بلا شعب كما كذبوا. ها هو كاتب آخر يعترف، ليس بوجود الشعب الفلسطيني، بل وبتفوقه على “الإسرائيليين”، هو (جدعون ليفي) الصهيوني اليساري، إذ يقول: يبدو أن الفلسطينيين طينتهم تختلف عن باقي البشر.. *فقد احتللنا أرضهم* وأطلقنا على شبابهم الغانيات وبنات الهوى والمخدرات، وقلنا ستمر بضع سنوات، وسينسون وطنهم وأرضهم، وإذا بجيلهم الشاب يفجر انتفاضة الـ87.. *وأدخلناهم السجون* وقلنا سنربيهم في السجون.. وبعد سنوات، وبعد أن ظننا أنهم استوعبوا الدرس، إذا بهم يعودون إلينا بانتفاضة مسلحة عام 2000، أكلت الأخضر واليابس.. *وقلنا نهدم بيوتهم* ونحاصرهم سنين طويلة، وإذا بهم يستخرجون من المستحيل صواريخ يضربوننا بها، رغم الحصار والدمار، *فأخذنا نخطط لهم بالجدار العازل* والأسلاك الشائكة.. وإذا بهم يأتوننا من تحت الأرض وبالأنفاق، حتى أثخنوا فينا قتلاً *وفي الحرب الماضية* حاربناهم بالعقول، فإذا بهم يستولون على القمر الصناعي “الإسرائيلي” (عاموس)؟ ويدخلون الرعب إلى كل بيت في “إسرائيل”، عبر بث التهديد والوعيد، كما حدث حينما استطاع شبابهم الاستيلاء على القناة الثانية “الاسرائيلية”. *خلاصة القول كما يقول الكاتب:* يبدو أننا نواجه أصعب شعب عرفه التاريخ، ولا حل معهم سوى الاعتراف بحقوقهم وإنهاء الاحتلال.
نجمة تنس تونسية: مدربي الفرنسي اغتصبني
أحمد فتحي رزق يكتب (وانتصف ليل القاهرة) قصة قصيرة
وانتصف لیل القاھرة
الناقد محمد حمدي الشعار في قراءة لرواية صباح يتنظر الفرح لأحمد فتحي رزق
من المعلومِ قطعًا أنّ أيٍّ من الأعمالِ الحكائيةِ، والرّوايةُ علىٰ وجهِ الخصوصِ يقومُ علىٰ عدّةِ مُقوّماتٍ أساسيّةٍ تُشكّلُ الدعامةَ الرئيسةَ في محتوىٰ الطّرحِ. تلكَ المُقوّماتُ التي لم يختلف عليها أحدُ النّقَدَةِ في تناولِ العملِ بالتّحليلِ أو الدّراسةِ، وتشملُ: اللّغةَ، والحيثيةَ، والحبكةَ، والسردَ، والعُقدةَ، وفي كلِّ ذلكَ يُبنىٰ العملُ علىٰ مُقدّمةٍ، وعرضٍ، وختامٍ. وها هو الأُستاذُ الرّوائيُّ/ أحمدفتحي رزق، يُطالعُنا بِمفهومٍ جديدٍ في روايتِه الواقعيّةِ صباحٌ ينتظرُ الفرجُ، تلك هي عتبةُ النصِّ الأُولىٰ، فوقَ التّقديمِ، والّتي اختارَها لِيعبُرَ من خلالِها إلىٰ قضيّتِهِ التي -أرىٰ- أنّها كانت شُغلّا شاغلًا لهُ قبلَ، وبعدَ، وأثناءَ السردِ الرّوائيِّ لأحداثِ عملِهِ هذا، تلك القضيّةُ التي سارعَ بالإفصاحِ عن محتواها بأسلوبٍ مُنسابٍ لا انكسارَ في مُحاياثاتِهِ الحكائيةِ منذُ أن وضعَ عنوانَهُ إلىٰ أن ختمَ مقاصدَهُ، ذلكَ حينَ صرّحَ علىٰ لسانِ الإعلاميِّ المعروفِ/ حاتم النّقلي بالأسبابِ المؤديةِ إلىٰ كثرةِ حالاتِ الانفصالِ، وزيادةِ مُعدّلاتِ الطّلاقِ من طريقِ الإشارةِ وطرحِ التساؤلِ علىٰ جمهورِ برنامجِه الإعلاميِّ، الذي تتابعُه (سماح) بطلةُ العملِ الأولىٰ، منذ أن كانت فتاةً في بيتِ أبيها. ذلك التعجيلُ الذي أفقدَ العملَ الروائىَّ جانبًا من شائقيّتِهِ، بيدَ أنّهُ لم يُؤثّر في التّبئيرِ لقضيّةِ الطَّرحِ مِن خلالِ اللعملِ علىٰ أبعادٍ أخرىٰ حملت بينَ طيّاتِها عددًا من القضايا الفرعيةِ المُؤثّرةِ في تلقّي العملِ برغبةٍ مُلحّةٍ لاستكمالِه . * لغةُ النصِّ: ساقَ الروائيُّ لغتَهُ صحيحةً مُشوّقةً جزلةً قويّةً، حتىٰ ما نعانيهِ الآنَ مِن ركاكةِ الصياغةِ، وضعفِ التراكيبِ في أكثرِ الأعمالِ الروائيةِ، إلّا أنّك تراهُ يقفُ بكَ علىٰ خلفيّةٍ لغويةٍ لديهِ نتيجةَ محصولٍ وافرٍ من الأساليبِ الإبداعيةِ لا تقلُّ في طبيغتِها عن كبارِ أدباءِ عصرِ الروايةِ فيما بينَ العقدينِ السابعِ والثامنِ من القرنِ المنصرمِ. * شخصيات النصّ: ولقد انتقىٰ الروائيُّ شخوصَ نصّهِ بِعنايةٍ نلحظُها مليًّا في تلك الاختياراتِ المُعبِّرةِ لأسمائِهم، فسماحُ تلك الفتاةُ التي لها من اسمِها نصيبٌ، لم يُلوّثها سوىٰ ما قامَ بهِ زوجُها (محمود) من سلوكياتٍ مشينةٍ لا تليقُ برجلِ تربيةٍ وتعليمٍ، ومنالُ، تلك المرأةِ التي ادّعت زمنًا صدقَ علاقتِها بسماحَ، غيرَ أنّها كانت تسعىٰ من ورائها إلىٰ منالٍ أعظمَ من تلك الصداقةِ، وحنانُ المرأةُ المثقفةُ العاملةُ في حقلِ الإعلامِ، والتي كانَ يجدرُ بها إن تكونَ علىٰ خلافِ ما بدا منها من الحنانِ إلىٰ الرجالِ الذين تُغلّفُ علاقتَها المشبوهةَ بهم بثوبِ العملِ . * حبكةُ النصِّى وقد ساقَ الروائيُّ النصَّ علىٰ وجهِهِ من غيرِ أن يقعَ في أكثرِها فيما يُخلُّ بمحايثاتِ بنائهِ، بل وإنّك لتقرأُ المشهدَ من روايتِه كأنّكَ تراهُ عيانًا؛ فقد أحسنَ ترسيمَ حدودِ الصورةِ الدراميةِ كأحسنِ ما يكونُ، فزاوجَ في العملِ بينَ خصائصِ الروايةِ وخصائصِ المسرحيةِ، مع فارقِ اختزالِ الحوارِ علىٰ حسابِ السردِ الوصفيِّ. * موضوعُ الطّرحِ: وأخيرًا لا يتّسعُ المقامُ للزيادةِ علىٰ القولِ بأنَّ الطّرحَ مع ما امتازَ بهِ من حملِهِ لخصائصِ الروائيِّ / أحمد فتحي رزق، وبصمتِهِ التي تمظهرَ شخصُهُ فيها بلغتِهِ وعرضِهِ، إلّا أنّه لم يخلُ من افتقادٍ لمُعالجةٍ حاسمةٍ لنوعِ تلك القضايا؛ وقد عرضَ لقضيةِ الطلاقِ، وبعضِ الأسبابِ المُؤدّيةِ إليهِ، جنبًا إلىٰ جنبٍ معَ عددٍ من القضايا الفرعيةِ، كالخياناتِ الزوجيةِ، وافتقادِ بعضِ العلاقاتِ الآدميّةِ إلىٰ الصدقِ.. وعلىٰ كلٍّ، فإنّ الروايةَ تستحقُّ الدراسةَ وفقًا لمستوياتِ التحليلِ الأسلوبيِّ؛ فمعانيها جمّةٌ، ومبانيها قويةٌ معبِّرةٌ، وطرحُها جيّدٌ.